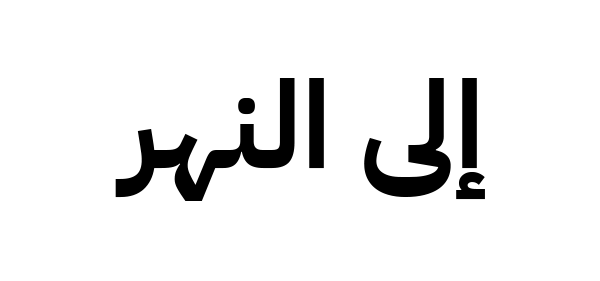مادة مكوّنة من جزئين كتبتها عن تفاصيل من رحلتي اليومية في المواصلات العامة “الكيّا”
(1)
(
أنتظر الحافلة بين التاسعة إلا ربع والتاسعة من صباح كل يوم، نسمّيها هنا “كيّا” وهي تسمية خاصة أطلقت على العام من هذا النوع من سيارات النقل.
يؤشّر السائقون بأيديهم ليصفوا المكان الذي تذهب إليه حافلاتهم، الكف يتحرك إلى اليمين معناه منطقة العَلاوي، إلى اليسار البيّاع، أما الحافلة التي تقلّني إلى ساحة النسور فإصبع السبابة يتحرك وكأنه ملعقة تذيب سكّر الشاي، أعني باتجاه دائري.
تحرجني هذه الحركة أحياناً، أبدو كأنني أذيب سكراً خفياً. تقف الحافلات التي تذهب إلى ساحة النسور، وهنا أكون بين موقفين: إن كانت الحافلة ممتلئة بالركاب ولا يخلو منها سوى كرسيّ واحد، أتجنب الصعود إليها، وإن كانت السيارة خالية من أي أحد، أكف نفسي عنها أيضاً. أمران دقيقان لكنهما مهمان: لا أريد أن أكون في زحام من أنفاس العابرين، ولا أن أكون وحيدة تماماً، في الزحام يُترك للراكب الأخير الكرسيّ الأسوأ، وفي الصعود وحيدة أخشى أن يقوم السائق بفتح موضوع معي فيشتتني عن انشغالي. وحتى تجيء الحافلة المناسبة، أنتظر عشر دقائق تحت شمس حارقة.
(2)
في الحافلة أختار الجلوس على الكرسي المجاور للباب، وفي هذا فوائد ومضارّ، الفوائد أنني سأستطيع النزول فوراً دون أن أربك بقية الركاب وأحركهم من أماكنهم فيما لو كانوا يجاورونني أو يجلسون أمامي، وهنا أنا في قلق عليهم وعلى نفسي أيضاً، فالحركة داخل مساحة ضيقة وسقف واطئ تظل فيها احتمالات إحراج، مثل أن أضرب رأسي بالسقف فيما أحاول النزول، أو أن أتعثر بأحد الركاب، وكلاهما يحدثان كثيراً.
المضارّ في أنني سأفتح الباب لمعظم الركاب الذين يصلون محطة نزولهم، فمكاني جوار الباب يجعلني أرفع عنهم حرج الانحناء لفتح الباب العالق في غالب الأوقات، أفتحه لهم وأغلقه وراءهم، وفي هذا تعب تعاني منه يدي.
أما إن كان المكان مشغولاً، فسأجلس في أي كرسيّ آخر متاح، أضع حقيبة الظهر بيني وبين الرجال الذين أجلس جوارهم لأستطيع الشعور بالراحة خلال الطريق، دونها سأظل قلقة. أما الحافلة المليئة بالنساء، فلا مسرّة أكبر من أن تكون نصيبي ذلك الصباح.
(3)
(
في مواصلات الصباح، آخذ بقراءة كتاب أحمله معي في الحقيبة، قبل أن أفعل ذلك أخرج الخمسمئة دينار لأعطيها للسائق، وهنا قد تحدث مسألة حرجة، أجرة الكيّا التي أستقلها هي خمسمئة دينار، أحياناً لا أحمل خردة فأعطي السائق ألفاً، وأعيش في حال من القلق: هل سيعيد إليّ ما بقي من الألف؟ أم سيتجاهلني؟ هل أطلبها منه؟ أم أتغافل وأسامحه بها.. نقاش يحدث كثيراً، وما أفعله يكون بهذا الشكل: حين يكون هناك ركاب كثيرون أخجل من طلب باقي الألف، حين نكون قلّة، أستطيع فعل ذلك بجرأة أفضل، وأحياناً، أتغاضى عن الأمر وأنفض النقاش من رأسي وأغمسه في الكتاب.
لطالما أحببت عالم الكيّا، وأطلقت على ما يحدث فيه من آراء وأحاديث وشخوص: آراء كيّاتية، وعالم كيّاتيّ.. فهو عالم صغير يجمع ناساً مختلفين بآراء وحيوات شديدة التنوع، مما يحوّل الطريق الذي يستغرق نصف ساعة أو ساعة، إلى حياة مصغرة نجتمع فيها، نتشارك الآراء السياسية، وأحزان الحياة، بعض الدموع والتذمر وشتم البلد، ثم فجأة نصيح: نازل.. ونترك هذا العالم يجمع آخرين ويكوّن حياة أخرى جديدة في غضون دقائق، بينما نكون قد انغمسنا نحن في النسيان.

سرعة تغيّره تجعله ثميناً، أحب أن أكون جزءاً من هذا العالم الوحشيّ والغريب، أحب سماع الآراء الساذجة والمخيفة. مرة صرّح رجل في الخمسين من عمره أمامي، قائلاً: حدث انفجار وقتل كثيرون قبل أعوام، كنت قريباً ورأيت الأجساد والدماء غير أنني لا أكترث، ليحترق هؤلاء الأغبياء والجهلة، ومضيت إلى صاحب عربة طعام وطلبت لفّة كباب، قال لي صاحب العربة وكان مرعوباً مما حدث: ألا ترى ما يجري في الشارع؟ قلت له: أريد لفّة حالاً، لا يهمني هؤلاء الناس، وليذهبوا إلى جهنم، آني شعلية؟
أتذكّر أنني خفت منه حين أخبرنا نحن رفاقه الكيّاتيون بهذه القصة، كيف يتحول الإنسان إلى هذه القسوة؟ دماء تملأ الشارع بينما يحمل لفة كباب ويأكل فوق جثثهم.
هناك صراعات حلوة تجري في عالم الكيّات، صرتُ في صباح ما محورها، كان هناك رجل وامرأة من عمرين قريبين، دخلا صراعاً بسبب المكان الذي اخترتُ الجلوس فيه. كان الجو حاراً ولم أرغب بالرجوع إلى آخر مقعد في الحافلة، جلست في المنتصف على الكرسي القابل للطيّ، وتركت المقعد الأخير فارغاً، قال لي الرجل: لماذا لا ترجعين إلى الوراء؟ أنت تحجزين مكاناً غير مناسب وسيأتي ركاب آخرون ويزعجونك. قالت له المرأة: دعها تجلس في المكان الذي تريد، وإلى أن يأتي ركاب آخرون الله كريم! يحلها حلاّل. ابتسمتُ، وأحببت رأي المرأة لأنه يوافق رأيي في تلك اللحظة، رغم أن مذهبي في الحياة يشبه مذهب الرجل: تجنّب ما قد يحدث. عكس المرأة التي كان مذهبها: ليحدث ما يحدث، وحتى يحين لنستمتع باللحظة.
ظلا طوال الطريق يتصارعان بطريقة صامتة، كلما يريد راكب جديد الصعود إلى الكيّا تتوتر الأجواء، وتتصاعد الأنفاس، وأستعد لخسارة الكرسيّ، وحين يغيّر الراكب رأيه، تنتشر الراحة والابتسامات المنتصرة. هذا ما كان يحدث لي وللمرأة، أما الرجل، فكان يتمنى أن يتحقق قوله، وطلب مني أكثر من مرة تغيير مكاني، تقوّيت بالمرأة وبقيت. حتى وصلت أخيراً محطتي الأخيرة، نزلت منتصرة، وودعت المرأة ذات المذهب الرائق والمتريث، والرجل صاحب التخطيط المسبق والمتأهب.
(4)
في كيّا أخذتها صباح أحد الأيام من العَلاوي إلى ساحة الطيران، وهي منطقة شعبية ومزدحمة وفيها يجتمع عراقيون من كل مكان، ويذهبون إلى كل مكان.. تكون هذه الكيّا في الصباح ممتلئة بالموظفين والذاهبين لإنجاز معاملات حكومية، ولا أتشاركها مع نساء كثيرات، فأكون وحيدة في عالم من الرجال ومشاكلهم التي تدور حول السياسة وإيجاد حلول لها.
في ذلك الصباح رأيت امرأة تصعد الكيّا معي، سررتُ، دعوت في قلبي أن تجلس جواري لكنها اختارت الرجوع إلى الوراء، كانت تفوح منها رائحة عطر رخيص، أو صابون قديم تبدلّ عطره، وبدأت تفعل شيئاً غريباً، كنت أستطيع رؤيتها حتى وهي ورائي، ورغم أن شكاً انتابني قليلاً، لكن حركتها أكدت لي، كانت المرأة تخلع ملابسها لترتدي أخرى.
أصابني توتر شديد، وارتعبت، حاولت إبعاد جسدي عن الكرسي، والتصقت بظهر الكرسي المقابل، رغبة بالابتعاد عن ما يحدث ورائي، كانت تخلع ملابسها حقيقة، ورأيت الرجل الذي يجلس جوارها يساعدها في ذلك، كان الجو مريباً، لست متأكدة من كون بقية الركاب قد شاهدوا أو أحسوا بما يجري، غير أنني رأيت بعض الرقاب تلتفت خطفاً وتنظر إلى الوراء. صمت ساد الكيّا، وبقيت بقلب يدق عنيفاً أتلهف للنزول. لكنها نزلت قبلي، ومعها نزل الرجل المساعد. لا أعرف عمل المرأة، ولا ما الذي دعاها لنزع ملابسها بين الناس، صحيح أنه عالم صغير يجمع حيواتنا، لكنه لا يمكن أن يصير بيتاً، أو غرفة. بقي قلق تلك الدقائق محمولاً مع تلك الذكرى، فكلما استعدتها هلّ معها ذلك الرعب والقلق وتخيّلات حول ما كان يمكن أن يحدث لو أنها جلست جواري.