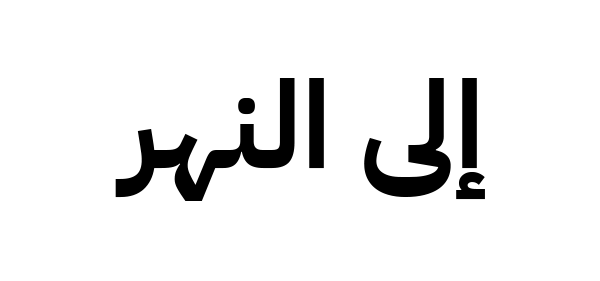لقد بقيت حياً لا لتعيش، لك وقت محدود
وعليك أن تدلي بشهادتك.
زبيغنيو هيربرت ـ شاعر بولندي
في تلك الأيام البعيدة، قبل عشرين سنة من الآن، كان الوقت ربيعاً أيضاً، ووحدها الطيور كانت تستطيع مغادرة البلد، إنه وقت هجرتها، أو فرصتها. أكاد أسمع أصواتها الصائحة الآن، حتى بعد مرور هذا الزمن، وهي تعبر من فوق البيت، أسراب كثيرة تصرخ.. هل كانت تحذرنا؟
غادرت الطيور مهاجرةً، وتركتنا وحدنا، للصيف، لفوضى الحياة التي تنتظرنا، ولخوف أن نظل عالقين هنا إلى الأبد محاصرين بصوت رصاص لا ينقطع. تهاجر الطيور مع كل صيف، وفي ذلك الوقت كان لديها سبب آخر للتحليق بعيداً، كانت تعرف بخبرتها أن شيئاً ما، مريعاً، سيحدث، وهي رقيقة، أهشّ من أن تحتمل، لذلك، ودعناها ونحن ننظر إليها تمرّ من فوق رؤوسنا، لوّحنا لها، وعدنا إلى بيوتنا نستعد لشيء آخر.
رحلت الطيور، وهي ترحل الآن أيضاً. أجلس لأتذكر مشاهد من الحرب فأسمعها تمر فوق سماء البيت مرة أخرى، وتصيح، التحذير مستمر، أسمعه ولا أستطيع فعل شيء سوى التذكر.
بداية
حين بدأت الحرب كنت طفلةً في العاشرة من عمري، أعيش وأسرتي حياة سريّة طريفة، فقد استطاع أشقائي الحصول على جهاز “دش/ستلايت” يبث من الأقمار الصناعية، وهو شيء كان ممنوعاً في زمن صدام حسين، والبيت الذي يُعرف بأن لديه جهاز بثّ محرم، تتم مصادرته.
ومع الطرافة، كان هناك قلق ننغمس فيه كلما أطلّت علينا وجوه مذيعي قناة الجزيرة تخبرنا باقتراب الحرب، علاماتها وتفاصيل ما قد يحدث، كلام المحللين والخبراء المنذر لنا من رعب قادم، أسلحة دمار شامل تختفي تحت رمال صحرائنا، فرق تأتي باحثة عنها، وأخرى تعود دون الحصول على أية معلومة، أشياء كنا نراها من خلال الشاشات فقط، ونكتشف من خلالها الحياة السرية للبلد الذي نعيش فيه، فبحسب أمريكا، كان العراق يخبئ عنا الكثير من حياته.
كنا نتلقى هذا القلق طيلة اليوم، غير أنه قلق لا نستطيع البوح به، كان علينا أن نكتمه، فالحياة خارج التلفزيون تجري هادئة، لا ملامح لأي خوف فيها أو ترقب، والعراق في الشارع لا يخفي شيئاً عن الناس، مكان بريء، متكتم، يداري أهله جوع حصار كان مع اندلاع الحرب قد مرّت عليه إحدى عشرة سنة، لا يفكرون سوى بوجبة جيدة، ويوم غدٍ فيه وجبة جيدة.
ورغم أن الحديث عن حرب وشيكة كان يُتداول بسرية بين الناس، لكن الحياة تمضي بإيقاعها المعهود، كان قد مر وقت طويل على وجود صدام حسين في حياة الناس، وحين يحدث هذا، يصير من الصعب تخيل الحياة دونه. شيء لا يزال صعب التخيل حتى اللحظة لكثير من الناس.
وكطفلة تملك وعياً سياسياً جيداً، كنت أسخر في سرّي من المعلمات اللواتي يخبرننا: لا يوجد شيء اسمه الحرب، هذه أخبار كاذبة، لا تستطيع بلدان العالم الوصول إلى أرضنا. كنت أعرف شيئاً آخر.
والشيء الآخر جاء فعلاً.
صباح يومٍ من آذار: برد خفيف، ومجرّد حرب قامت
هل كان يوم خميس؟ في صباح بارد من آذار، غرب الأنبار، أقرب إلى الحدود السورية منا إلى بغداد، المكان كان المطبخ، هذا أول ما أتذكره حين أستعيد ذلك اليوم.
استيقظت كأي يوم للذهاب إلى المدرسة، وتوجهت إلى المطبخ لأتناول فطوري، كان معتماً، ورغم أنه يوحي بهذا الإحساس بشكل دائم، لكنه في ذلك الصباح كان أشد عتمة، كأن غيمة ثقيلة حطت عليه وخنقت ضوءه.
في البيت كنا نعرف أن الحرب وشيكة، نعرفها كمعلومة تلفزيونية، لكن من يصدقها؟ دخلت المطبخ، كانت على الأرض سفرة طعام صغيرة، شاي وخبز ونوع واحد من الجبن المعد منزلياً، سألت أمي أن تعطيني شيئاً ما لا أتذكره، فردت عليّ بغضب، هذا النوع من الغضب الذي يصيب الإنسان حين يحزن بشدة ولا يستطيع فعل شيء تجاه حزنه. ورغم أنني الآن لا أتذكر كيف سألتها عما حدث، لكنني أتذكر إجابتها حين قالت: الصبح قصفوها.. وكنت أعرف أن الـ”ها” هنا، تعود إلى بغداد. قصفوا بغداد، وشيء ما سيتغير إلى الأبد.
إلى الأبد ربما، لكن ليس اليوم. حملت حقيبتي وتوجهت إلى المدرسة، كطفلة لم أكن أعرف أبعاد وتأثيرات ما حدث ـ على افتراض أن البالغين يعرفون ـ لا أتذكر أي حديث دار في المدرسة عن الحرب، الجميع يعرف، والجميع يتصرف كأن شيئاً لم يحدث، وصدام حسين كان يحدق بنا من كل مكان في المدرسة، وجهه الحازم يحذرنا من التصديق.
مر يومان، درسنا فيهما بشكل طفيف ثم قالت لنا المديرة: عودوا إلى بيوتكم، لا مدرسة بعد اليوم.
وعدت، تغمرني سعادة لم أجربها في حياتي، مسرّة صافية، حصلت على عطلة غير محددة بزمن، ما أهمية الحرب أو آثارها الآن؟ ركضت إلى البيت، قطعت الشوارع بسرعة وفتحت باب البيت الخارجي تاركة الحقيبة في الحديقة، أعدو لأخبر أمي بأمر العطلة كأنه أهم حدث في حياتنا كلنا. في تلك اللحظة، صُدمت بأول أحداث الحرب وآثارها.
الحرب كانت هنا، في البيت.
لم أجد أمي في البيت، لكنني وجدت أناساً آخرين لا أعرفهم، غرباء. هلعت، أين ذهبت أسرتي؟ فتحت باب أول غرفة وكانت فيها امرأة في خمسينياتها ربما، أعرفها قليلاً غير أنني لست متأكدة من تكون. انسحبت الضحكة السعيدة من وجهي وأنا أفتح باب الغرفة الأخرى لأجد فيها امرأة وأطفالاً لم أرهم من قبل. ماذا يحدث؟ أكملت البحث عن أمي حتى وجدتها أخيراً في حديقة البيت الخلفية، تشغل نفسها بعمل ما، وتبعد تفكيرها عن ما يحصل في البلد. كنت لحظتها قد نسيت أمر العطلة، قلبي يدقّ: من هؤلاء الغرباء يا أمي؟
لم يكونوا غرباء، لكنها المرة الأولى التي يزورون فيها المدينة. أقارب هربوا من الحرب في العاصمة إلى مدينتنا الصغيرة ليحتموا ببعدها الجغرافي من صواريخ أمريكا المحررة. حين أخبرتني أمي بذلك، ازدادت الإثارة، هناك أشياء جديدة تحدث، جديدة وكثيرة، وإيقاع المدينة الرتيب يتغير، كان كل شيء أمامي ينضح بالبهجة، أنا أمام لعب لا منته، عطلة ممتدة، وأصدقاء جدد.
لكن الطفولة كانت على وشك أن تنكسر، على بعد صفارة إنذار واحدة لتتحول إلى وعي جديد بما يحدث، بأن ما هو أمامي ليس عطلة سعيدة.

الوداع أيتها الطفولة المرحة
في كل مرة أتذكر فيها الحرب، أو تذكر أمامي، أشعر بالخجل لأن معظم ذكرياتي عنها كانت مرحة، ربما ليست كل الحرب، لكل صورتها الأولى، أول الأسابيع، الفورة والصدمة، كنت فيها فتاة سعيدة، انفتحت لي فيها عوالم جديدة: حدث غريب ومثير، أقارب وأصدقاء أحضروا عوالمهم البعيدة معهم إلى بيتي، وكانت كلها في متناول يدي، منصتة، دهشة، وجسدي كله يقفز مسرّة.
رغم ذلك، تعرضت هذه المسرة للقطع أكثر من مرة، أولها وأكثرها حضوراً في ذاكرتي حين جاءت الطائرات الأمريكية ليلاً، تقصف، وتشتبك، وتغرق المدينة بالظلام، جاءت تنبش الحياة السرية لمدينتنا الصغيرة الكتومة، وللصحراء التي لم نعرف عنها حكاية سيئة، ليلة قاسية، تعرفت فيها إلى صوت صفارة الإنذار المرعب لأول مرة في حياتي، لا أتذكر أنني سمعته بعد تلك الليلة مطلقاً، كأن ما حل بنا صار معتادا، نتوقعه كل ليلة، ولا شيء يستدعي الإنذار.
المدينة أظلمت في تلك الليلة، جلسنا كلنا في غرفة واحدة وامتنعنا عن مغادرتها، وكنا نخاف أن يخرج منها أحد حتى وإن ذهب إلى الحمام، كأن الخروج من الغرفة يعني الخروج إلى العراء، إلى مواجهة مباشرة مع الطائرات الأمريكية المتوحشة، إلى الانكشاف أمام الموت. أغلقنا النوافذ وأسدلنا الستائر، كأننا نخشى أن تلمحنا الطائرات الأمريكية أحياء، وتقصفنا لهذا الجرم.
ليلتها لم تكن أمي في البيت، ذهبت في بداية المساء لزيارة شقيقتها القادمة من العاصمة هرباً من القصف والنيران إلى مدينة ظنتها في منأى عن كل ذلك، لكنه لاحقها، وفي تلك الليلة فعلت أمي شيئاً شجاعته مخيفة، فلم تحتمل البقاء في بيت شقيقتها، وقررت المغادرة في وقت حرج وخطير، خرجت تسير مخترقة الليل والرصاص وظلمة الخوف التي حطت على بيوت المدينة، ووصلتنا، سالمة، خائفة، وشجاعة.
مرت تلك الليلة لا أدري كيف، استيقظنا نحاول التواصل مع الآخرين من سكان المدينة لنعرف ما جرى: ما قصف، ومن قتل. غادرت الطائرات، والكهرباء، وأزعم أن طفولتي غادرت معهما، استيقظت، اكتشفت الحرب لأول مرة، إذن هذه هي، والليالي السعيدة محض خداع!
لا أتذكر الليالي الصعبة التي مرت بعدها حتى سقوط بغداد، محتها ذاكرتي واحتفظت بأول ليلة خوف، ليلة التحوّل، الوعي بفكرة الحرب وما قد تفعله بحياتنا.
إلى حروب أخرى أيتها الحياة السعيدة
انقطعت الكهرباء عن المدينة شهورا، عشنا تجربة لم نألفها من قبل مع الظلام، ومع العودة في السنوات إلى ما قبل اختراع الكهرباء، من حسن حظ عائلتي أننا نملك أرضا زراعية وكانت الحكومة قد منحتنا مولدا كهربائيا يعمل بالكاز، وضعناه في البيت ووزعنا الكهرباء على الجيران كلهم، وتركنا في البيت مجمدة لكل نساء الحي اللواتي يرغبن بوضع خضراوات مجمدة فيها، يأخذن منها قدر حاجتهن ليطبخن غداء كل يوم، وكم يبدو الأمر طريفا الآن حين أتذكره، عندما كنت أستيقظ من النوم وأخرج إلى بهو البيت لأرى نساء غريبات محنيات الرؤوس ينبشن في المجمدة بحثا عن طبخاتهن.
أتذكر الشاعر الأمريكي الصربي تشارلز سيميك وهو يتساءل في مذكراته: “هل صحيح أن المرء يتلبسه الحنين للأهوال عندما يتقدم في العمر؟”
هل إنني أتوهم الحرب كانت سعيدة لأنني كنت طفلة؟ من يمكنه أن يعرف؟ ما أعرفه أن الحرب لم تنته، عدنا إلى الدراسة بعد سقوط بغداد، امتحنّا، وانتقلت إلى مرحلة دراسية جديدة، لا صدام فيها، لا صورته في كل زاوية من زوايا المدرسة، ولا أحد يهددني فيما لو لم أذهب إلى مسيرة مؤيدة له، أو لم أنضم لاحتفال عيد ميلاده، انتهى كل ذلك، ولست أدري إن كنت سعيدة أم حزينة، إنه شيء حدث وحسب، لم تمهلنا الحياة للتأمل والنظر فيه، أمسكت بداية الحرب رؤوسنا وأدخلتها في طين حروب أخرى لم تتوقف، وكلما نحاول رفع رؤوسنا، التقاط الهواء، تغمسنا في طينها بشدة أكبر.
لكنني، حتى اليوم لا أنسى حين عدنا بعد سقوط بغداد إلى المدرسة، وفي درس العلوم، اقتربت مني المعلمة ورأيت ساعتها اليدوية التي كان صدام حسين يبتسم في خلفيتها، أظنني خفت لحظتها، وهو مشهد يعود إلي دائماً، أتخيلها خلعت الساعة بعد مرور السنوات، لكنها ظلت محتفظة بها في ركن قصيّ من خزانة ملابسها، لتذكرها بين وقت وآخر بذلك الزمن، وتلك الحياة. وربما لكل واحد كان واعياً في تلك الحرب مثل هذه اللحظة، يعود فيها إلى الوراء ليستوعب ما حدث، كيف بدأت الحرب، كيف اختفى صدام فجأة من حياة طويلة كان فيها معنا، وكيف وصلنا الآن هنا.
لا نهاية لهذه المادة، فلا نهاية للحرب التي بدأت في حياتنا، لكنني أتذكر مرة أخرى إحدى الشخصيات في مذكرات تشارلز سيميك وهي تقول له: “عندي انطباع أن الليالي في حياتي أكثر من النهارات، كأن الليل يكون على وشك أن ينتهي، ومن المفترض أن يبدأ نهار جديد، لكن يحل محله ليل آخر بسرعة”. ونحن، على هذه الأرض، مثلها.